سلسلة النظريَّات البديلة من نظريَّة العامل النحويِّ(1) (نظريَّة الأستاذ إبراهيم مصطفى)
سلسلة النظريَّات
البديلة من نظريَّة العامل النحويِّ(1)
(نظريَّة الأستاذ
إبراهيم مصطفى)
أ.
محمَّدإبراهيم
محمَّدعمر همَّد محمود
مقدمة:
وجد المحدثون أنفسهم أمام تراث نحويٍّ ثرٍّ
من أمَّهات الكتب النحويَّة، وتعليقاتها وشروحها وحواشيها، وكانت تلك الكتب تحتوي
على قضايا النحو وتفصيلاته الجزئيَّة، وكان على المحدثين التعامل مع هذا التراث
بالنقد والتحليل، وقد كان للعامل النحويِّ نصيب من النقد والتوجيه. وقد
انقسم المحدثون إزائه إلى معارض له، يدعو
إلى التخلص منه، ومؤيِّد يدافع عنه ويشدِّد على أهميَّته. وحاول كلٌّ من الفريقين
تبرير دعوته والتأكيد على صحتها
ويُعَدُّ إبراهيم مصطفى صاحب أوَّل محاولة نقديَّة متكاملة لمفهوم
العامل النحويِّ في العصر الحديث، وذلك في كتابه ( إحياء النحو) وقد انطلق في نقده
من مبدأ صعوبة الدرس النحويِّ وفقاً لنظريَّة العامل النحويِّ.
دواعي نشأة النظريَّة وأهدافها:
كان إبراهيم مصطفى من المهتمين بالنحو
تعلُّماً وتعليماً، فقد درسه بالأزهر ثم كان على علاقة وثيقة بتدريسه في الجامعات
والمعاهد المصرية. وقد وجد النحو شاقاً يتبرَّم الدارس من دراسته، ويضيق صدره من
تحصيله، ولأجل ذلك وُجِدَتْ كتبٌ تحمل أسماء مثل: (التسهيل)، و(التوضيح)،
و(التقريب)، هذا بالإضافة إلى المنظومات النحويَّة التي تحفظ قواعده، وتعمل على
ضبط شوارده. وقد لاحظ أنَّ النحو قد يكون له القول الفصل في السهل من القول من رفع
الفاعل ونصب المفعول، إلا أنَّه يعتريه الاضطراب عندما يعرض إلى بعض الأساليب
والمواضع الدقيقة، فحينها لا يمكن للنحو إسعاف الطالب بالقول الفصل، بل يجد اضطراب
الآراء وكثرة الجدل. لكلِّ ذلك قرَّر إبراهيم مصطفى أن يعمد إلي طريقة تغيِّر من
منهج تدريس هذا النحو، وترفع عن دارسيه هذا الإصر الذي احتملوه، فكتب هذا البحث
النحويَّ الذي قال عنه:((عكفت عليه سبع سنيين، وأقدمه إليك في صفحات، سبع سنين من أوسط أيام العمر وأحراها
بالعمل، صدقت فيها الاعتكاف إلى النحو، وإلى ما يتصل بمباحثه، وأضعت له من حق
الصديق والأهل والولد والنفس جميعاً.)).(1) وهو إذ يكتب هذا البحث الذي يقدِّم فيه
منهجاً جديداً لدراسة النحو كان يهدف إلى تحقيق بعض الأهداف، ومنها:
أولاً- البحث في معاني علامات الإعراب: وقد تساءل
إبراهيم مصطفى عن فحوى تلك العلامات ومدى أهميَّتها وأثرها على الكلام، فما الذي
تحمله هذه العلامات من معانٍ تشير إليها في الكلام، وما إذا كانت تصوِّر شيئاً في
نفس المتكلم وتؤدِّي به إلى ذهن السامع، وإذا لم يكن لتلك العلامات معانٍ
فلِمَ حرصت العربيَّة على الاحتفاظ بها وهي لغة
الإيجاز والاختصار، حيث تُحْذَفُ الكلمة أو الجملة أو الحرف لدليل عليه، فلِمَ
لَمْ تُحْذَفُ تلك العلامات. وقد وجد أنَّه ((قلَّ أن يشعرنا النحاة بفرق بين أن
تنصب أو ترفع، ولو أنه تبع هذا التبديل في الإعراب تبديل في المعنى، لكان ذلك هو
الحكم بين النحاة فيما اختلفوا فيه، ولكان هو الهادي للمتكلم أن يتبع في كلامه
وجهاً من الإعراب.)).(2) وهو بذلك يشير إلى أنَّ النحاة لم يولوا هذه المعاني
لعلامات الإعراب اهتماماً كافياً إذ يجيزون في بعض الأساليب أكثر من إعراب في
الكلمة الواحدة، كأنَّما تلك العلامات ليس لها أثر في تغيير المعنى، وهو الأمر
الذي اهتمَّ بتتبّعه إبراهيم مصطفى ليتوصَّل إلى معاني تلك العلامات الإعرابية،
والتي ستكون دليل المتكلِّم إلى معرفة المعنى التركيبيِّ للكلمة في الجملة.
ثانياً - هدم نظريَّة العامل النحويِّ: وقد وجد أنَّ
هذه النظريَّة هي السبب في تعقيد النحو العربيِّ، فضلاً عن كونها سبباً من أسباب
الجدل بين النحاة، وعلى أساسها تمَّ تفضيل بعض اللغات على بعضها الأخر، بالإضافة
إلى رفض بعض الأساليب العربية الصحيحة
التي تخرج عن نطاق قواعد هذه النظريَّة،
ليس هذا فحسب بل شُرِعَتْ أساليب جديدة لم تُسْمَعْ بل قاسها النحاة لطرد قواعدهم
في العامل، كما أنَّ النظريَّة قد اختلطت بفلسفة كلاميَّة غلبت على التفكير
النحويِّ .(3) لذلك قرَّر أن يهدم بنيان تلك النظريَّة التي لم تفلح في تسهيل
قواعد النحو العربيِّ، وقد آن لها أن تفقد سلطانها القديم، وسحرها عند النحاة
((ومن استمسك بها فسوف يحس ما فيها من تهافت وهلهله، وستخذله نفسه حين يبحث عن
العامل في مثل التحذير والإغراء، أو الاختصاص أو النداء، ثم يري أنه يبحث عن غير
شيء.))(4) وهو إذ يهدم هذه النظريَّة فإنَّه يقيم على أنقاضها نظريَّته الخاصَّة
والتي سوف تيسِّر النحو العربيَّ، وتختصر أبوابه، وتضع القواعد على أساس يجمع بين
المعنى والإعراب.
ثالثاً- تغيير وجهة البحث النحويِّ: وقد رأى إبراهيم
مصطفى أنَّ النحاة قد ضيَّعوا حدود البحث النحويِّ بقصرهم إيَّاه على الحركات
الإعرابيَّة، وما يتعلَّق بها من عوامل كانت سبباً في وجودها، حيث لم يولوا
عنايتهم الكافية لطرق الإثبات والنفي والتوكيد والتأخير والتقديم إلا في نطاق
ضيِّق يتعلَّق بالإعراب، أو يتَّصل بأحكامه. وهم بذلك قد ضيَّقوا على أنفسهم وعلى من جاء بعدهم حدود النحو،
وحرموا الناس من الاطلاع على كثير من فقه العربيَّة وأساليبها، ودقَّة تصويرها،
وقدرتها في التعبير بأساليب متنوعة. كما رسموا بذلك طريقاً لفظيَّاً لدراسة النحو
العربيِّ، يهتمُّ ببيان اختلاف حالات اللفظ من رفع أو نصب أو جرٍّ، دون أن يكون
ذلك مقروناً بتتبّع هذه الأوجه وما تتركه من أثر في تحديد المعنى.(5)
أصول نظريَّة إبراهيم مصطفى:
أطال إبراهيم مصطفى النظر في تتبُّع علامات
الإعراب محاولاً أن يستخلص منها معانٍ تدلُّ عليها، وقد اهتدى في بحثه عن تلك
المعاني إلى أنَّ الضمَّة تدل على معنى الإسناد في التراكيب، والكسرة تدل على
الإضافة، أما الفتحة فليست بعلامة إعراب وليس لها معنى تدلُّ عليه، وإنَّما هي
حركة خفيفة مستحبَّة لدى العرب تزيِّن آخر الاسم في التركيب متى ما أمكن ذلك، فهي
عندهم أشبه بسكون العامَّة.(6) وسيتمُّ التطرق لهذه الأصول بشيء من التفصيل.
الأصل الأول– الضمَّة علامة الإسناد:
يرى إبراهيم مصطفى أنَّ الضمَّة علامة
الإسناد، فوجودها على الكلمة في التركيب يدلُّ على أنَّها مسند إليها أو متحدث
عنها. وأي ضمَّة سوى تلك يكون سببها البناء أو التبعيَّة لاسم مسند إليه.
ويؤكِّد
ذلك أنَّ كلَّ مسند إليه في الجمل لا يأتي إلا مرفوعاً، وذلك كما في الفاعل، ونائب
الفاعل، والمبتدأ. ولا يخرج عن هذا الأصل سوى المنادى الذي يكون علماً مفرداً، أو
نكرة مقصودة، وهو يأتي مضموماً، وهو بذلك يخالف الأصل الذي وضعه إبراهيم مصطفى من
أنَّ الضمَّة علامة الإسناد، ومع ذلك لا يعدم إبراهيم مصطفى دليلاً يؤكِّد عدم
مخالفة المنادى للأصل الذي وضعه، حيث
يعتبر هذه الضمَّة ضمَّة بناء وليست بضمَّة إعراب كما قال النحاة القدامى، ولكنَّه
يخالفهم في السبب الذي بُنِي لأجله هذا الاسم على الضمِّ في النداء، ويرى أنَّ
الاسم في النداء كان من المتوقَّع أن ينوَّن، ولكن التنوين يدل على التنكير،
والعلم والنكرة المقصودة يدلَّان على التعيين، لذلك حُذِفَ التنوين، فإذا حُذِفَ
منه التنوين بقى له حكم النصب، فأُشْبِهَ
بالمضاف إلى ياء المتكلِّم، لأنَّها تقلب في باب النداء ألفاً، إذ تقول: يا غلامي،
ويا غلاما، وقد تُحْذَفُ الألف وتبقى
الحركة نحو: يا غلامَ، لذلك فرُّوا في هذا
الباب من النصب والجرِّ إلى الضمِّ اتقاءً لشبهة الإضافة إلى ياء المتكلَّم.(7)
وكذلك مما يخرج عن هذا الأصل اسم (أنَّ) والذي من حقِّه أن يأتي مرفوعاً وفقا
لنظريَّة إبراهيم مصطفى، إلَّا أنَّه يأتي منصوباً وفقاً لنظريَّة العامل، و لا
يرى إبراهيم مصطفى في ذلك خروجا عن أصله بل يرى:((أن النحاة قد أخطأوا فهم هذا
الباب وتدوينه، ثم تجرؤوا على تغليط العرب في بعض أحكامه.))(8) ثم يحتجُّ لرأيه
هذا بعدَّة أدلَّة -من القرآن والحديث النبويِّ والشعر- ورد فيها اسم أنَّ مرفوعاً
مطابقاً لأصله الذي وضعه، ومخالفاً لرأي النحاة الذين جعلوا من حقِّه النصب لا
الرفع. ويستشهد من القرآن بقوله تعالى: {إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ }(9)
ووجه الاستدلال عنده
أنَّ من القراء من قرأ (إنَّ هذان)، بتشديد نون (إنَّ) ورفع (هذان)،(10) وهذا يعنى
أنّ اسم (إنَّ) حقّه الرفع، ويقوِّي ذلك
عنده أنَّ اسم (إنَّ) قد عُطِفَ عليه بالرفع، وذلك كما في قوله تعالى: ﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ
ﲺ ﱠ(11) وفي الآية الكريمة عُطِفَ
(الصابئون) وهو مرفوع على اسم إنَّ(الذين)الذي هو في موضع نصب. كما جاء في الحديث
اسم إنَّ مرفوعاً في قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم:(( إنَّ من أشدِّ الناسِ
عذاباً يومَ القيامةِ المصوِّرون.)).(12) فــــــ(المصورون) اسم إنَّ ومع ذلك فهو
مرفوع. كما جاء المعطوف على اسم (إنَّ) مرفوعاً في الشعر كقول الشاعر:
وَإلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّا
وَأَنْتُم [الوافر]
بُغاةٌ
ما بقينا فِي شِقاقٍ(13)
حيث
عطف على اسم إنَّ ضمير الرفع (أنتم) فدلَّ
ذلك على أنَّ حقَّه الرفع. أما عن غلبة النصب على اسم إنَّ فسببه عند إبراهيم
مصطفى أنَّ العرب قد أكثروا من استخدام (إنَّ) مع ضمير النصب،
حتى
توهموا أنَّ الموضع موضع نصب، لذلك لما استعملوها مع الاسم الظاهر نصبوا الاسم
بعدها على التوهم.(14) وبذلك يطَّرد الأصل الذي وضعه من أنَّ الرفع علامة الاسناد
فلا يشذُّ عنه شيء عنده.
الأصل الثاني – الكسرة علامة الاضافة:
ويذكر إبراهيم مصطفى في كتابه أنَّ الكسرة
علامة الإضافة، بمعنى أنَّ الاسم قد أضيف إلى غيره، سواء أكانت هذه الإضافة بأداة
نحو: مطرٌ مِنْ السماءِ، أم بلا أداة نحو: مطرُ السماءِ. ولا توجد كسرة في سواهما
إلَّا ما كانت كسرة بناء أو مجاورة كما في
الجرِّ على المجاورة. وهو بذلك يوافق النحاة في هذا الاصل، ويؤكِّد هذا بنقل عن
سيبويه كقوله:((والجرُّ إنما يكون في كلّ اسمٍ مضافٍ إليه، واعلم أنّ المضاف إليه
يَنْجَرُّ بثلاثة أشياء: بشيء ليس باسم ولا ظرفٍ ]يعني الحرف[ وبشيء يكون ظرفا،
وباسم لا يكون ظرفا)).(15) و بنصٍّ آخر عن المبرد وهو قوله:((هذا باب الإضافة وهي في الكلام على ضربين: فمن المضاف إليه ما
تضيف إليه بحرف جر، ومنه ما تضيف إليه اسما مثله فأما حروف الجر التي تضاف بها الأسماء
والأفعال إلى ما بعدها فمن وإلى ...)).(16) ويستكثر ابراهيم مصطفى من النصوص التي
تؤكِّد وجود هذا الأصل عند النحاة، ليثبت
به أنَّ الضمة علامة لمعنىً هو الإسناد، طالما أنَّ الكسرة علامة لمعنىً هو
الإضافة.(17)
الأصل الثالث– الفتحة ليست علامة لمعنىً:
حيث
أنَّها لا تدلُّ على معنىً كالضمَّة والكسرة، وإنَّما هي الحركة الخفيفة
والمستحبَّة عند العرب، والتي يُشكَلُ بها آخر كل كلمة في الوصل. وهو اذ يعتبر
الفتحة حركة خفيفة ومستحبَّة عند العرب، فإنَّه لا يرسل القول على عواهنه، وإنَّما
يحشد له من الأدلة ما يؤكِّد صحته، حيث يستشهد على خفَّه الفتحة بأدلَّة صوتيَّة
منها: أنَّ الفتحة القصيرة أو الطويلة (الألف) تُنْطَقان بإرسال النفس مع ترك مجرى
الهواء مفتوحاً اثناء النطق بلا عناء في
تكيفية. وهذه الطريقة لنطق الفتحة بنوعها فيها من السهولة والخفَّة مما لا يتوفر
للضمَّة والكسرة بنوعيهما، حيث تكلَّف الأولى الناطق ضمَّ الشفتين واستدارتهما،
بينما تكلِّفه الأخرى تكسّر مجرى الهواء وانحناء طرف اللسان عند اللثَّة. وكذلك
الفتحة أخفُّ في النطق من السكون حيث يستلزم الأخير ضغط النفس عند مخرج الحرف كما
في (أَبْ) مثلاً . بل إنَّ العرب يميلون إلى التخفيف فيسكنون (عين) الثلاثي إذا
كانت مضمومة مثل: (رُسُل)، أو مكسورة مثل: (فَخِذ)، ولا يخفِّفون بالتسكين إذا كانت (عين) الاسم مفتوحة مثل: (جَمَل).
وهذا يدلُّ على أنَّ الفتحة أخفُّ من السكون، ولوكان العكس لمضوا في التخفيف
بتسكين مفتوح (العين) إسوة بمضمومها ومكسورها، ليس هذا فحسب بل إنَّ من العرب قد يفرِّون من السكون إلى الفتح في بعض المواضع
كما في جمع المؤنث السالم للمفرد (فَتْرَة) حيث يجمع على (فَتَرات). وقد كانت
(العين) ساكنة في المفرد، وكان يلزم من ذلك بقاؤها ساكنة كذلك في الجمع، لأنَّ الجمع
جمع تصحيح فلا تغيَّر فيه صورة المُفرد من
حيث عدد الحروف وحركاتها. فدلَّ فتح العين في الجمع على خفَّة الفتحة مقارنة
بالسكون.
أمَّا كونها ليست بعلامة إعراب، فهذا أمر يحشد له إبراهيم مصطفى
أدلَّة أخرى تؤكِّد صحته، فمن ذلك ما أجازه النحاة من نقل حركة الإعراب إلى الحرف
الساكن الذي يقع قبل حرف الإعراب في حال الوقف إذا كانت حركة الإعراب ضمَّة نحو:
هذا البدْرُ، إذ يجوز في حال الوقف نقل الضمَّة إلى الساكن (الدال) الذي يقع قبل
حرف الإعراب (الراء) فيُنْطَقُ(البدُرْ). وكذلك الأمر إذا كانت حركة الإعراب كسرة
نحو: نورُ البدْرِ، فيجوز في حال الوقف أنْ يُنْطَقُ(نورُ البدِرْ)، ويمتنع ذلك
النقل في حال الوقف إذا كانت حركة الإعراب فتحة نحو قولك: انظرْ البدْرَ.(18) فوجه
الاستدلال فيما ذُكِرَ أنَّ العرب قد فرقت
بين الضمَّة والكسرة من جانب والفتحة من جانب آخر، فاحتفظت بالضمَّة
والكسرة دون الفتحة، وذلك لأهميَّتهما وكونهما دليلين على معنيين هما الإسناد
والإضافة، ولامعنىً تدلُّ عليه الفتحة، لذا لم يُحْتَفَظ ْبها في حال الوقف كما
فُعِل بالضمَّة والكسرة.(19)
علامات الإعراب الفرعيَّة:
وبعد أن قرَّر إبراهيم مصطفى أصول نظريَّته
النحويَّة، فإنَّه انتقل إلى مناقشه العلامات الفرعيَّة للإعراب، والتي لا يقرُّ
بوجودها، بل يرى أن تقسيم العلامات الإعرابية إلى أصليَّة وفرعيَّة من اختراع
النحاة، ولم تكن هنالك من حاجة إليه. فالأسماء الستة: أبوك، وأخوك، وحموك، وهنوك،
وفوك، وذو مال، تُعرَبُ عند النحاة
بالحروف النائبة عن الحركات، حيث تنوب الواو عن الضمَّة، والألف عن الفتحة، والياء
عن الكسرة .أمَّا هو فيعتبرها معربة بالحركات، فالضمَّة للإسناد، والكسرة للإضافة،
والفتحة لغير ذلك. أمَّا ما اعتبره النحاة حروفاً تنوب عن الحركات الإعرابيَّة فهو
يراه إشباعاً للحركة الاعرابيَّة نفسها، فالواو ناتجة عن إشباع الضمَّة، والياء عن
إشباع الكسرة، والألف عن إشباع الفتحة، وهذا الإشباع له ما يبرِّره في تلك
الاسماء، حيث أنَّ (فاك، وذا مال) موضوعتان على حرف واحد، فتمَّ إشباع الحركة
الإعرابيَّة لإكمال هذا النقص في حروفهما، أمَّا بقيَّة الأسماء الستة فتم إشباع
حركاتها الإعرابيَّة لأنها على حرفين أحدهما حرف حلقيٍّ، وحرف الحلق ضعيف في
النطق، قليل الحظ من الظهور، فتمَّ إشباع
الحركات الإعرابيَّة لسدِّ هذا النقص ولتلحق بالأسماء الثلاثيَّة، ويعزِّز هذا
الرأي أنَّ هذه الأسماء تُعْرَبُ بالحركات متى ما ابتعد عنها عارض النقص بتنوين أو
تعريف، ويقرُّ إبراهيم مصطفى بأنَّه قد استقى هذا الرأي من أبي عثمان
المازنيّ.(20)
أمَّا جمع المذكر السالم فالضمَّة علامة الإسناد فيه، والواو إشباع لها،
والكسرة علامة الإضافة، والياء إشباع لها، وبما أنَّ الفتحة ليست علامة إعراب فلذا
لم يظهر لها شيء في جمع المذكر السالم، بل أُشْرِكَتْ مع الكسرة، وهذا يوافق الأصل
الذي وضعه من أنَّ الفتحة ليست علامة إعراب، ويؤكِّد ذلك أيضاً أنَّ جمع المؤنث
السالم يُرْفَعُ بالضمَّة، ويُنْجَرُّ بالكسرة، ولم توضع للنصب علامة فيه بل
أُشْرِكَ في الكسرة مع الجرِّ.
أمَّا الممنوع من الصرف فإنَّ النحاة يرونه
ينجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو يختلف معهم في ذلك حيث يعتبر هذه الفتحة ليست
علامة إعراب فرعيَّة، وإنَّما هي فتحة بناء، وسببها أن الاسم قد حُرِم التنوين
فصار أشبه بالمضاف إلى ياء المتكلِّم في حال الكسر، وبما أن ياء المتكلِّم
تُحْذَفُ أحياناً، لذلك لجأ العرب إلى الفتحة فراراً من هذه الشبهة – شبهة الإضافة
إلى يا المتكلِّم . فمتى ما أَمِنُوا تلك الشبهة بتعريف أو إضافة فإنَّ الكسرة
تعود للظهور مجدداً في آخر الاسم، وهذا ما يوافق أصله الذي وضعه من أنَّ الكسرة
علامة الإضافة.
ولم يشذُّ عن تلك الأصول التي وضعها سوى باب
المثنى، ويقرُّ إبراهيم مصطفى بهذا الشذوذ، وهو شذوذ يعزوه إلى غرابة هذا الباب في
العربيَّة، والذي يشبه في شذوذه باب العدد، حيث يذكَّر المؤنَّث فيه ويؤنَّث
المذكر. وكذلك الأمر بالنسبة للمثنى حيث تعبِّر عنه العرب أحيانا بالمفرد، وأحيانا
بالجمع ، لذلك لا يقدح هذا الشذوذ في صحة الأصول التي وضعها لتفسير علامات الإعراب
طالما انتظمت فيها بقيَّة الأبواب الأخرى.(21)
المرفوعات عند إبراهيم مصطفى:
سبق أن قرَّر إبراهيم مصطفى أنَّ الضمَّة
علامة الإسناد، ولتطبيق هذا الأصل عمليَّاً جعل من الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ
باباً واحداً. وحكم هذا الباب الرفع لأنَّه مُسْنَدٌ إليه أو مُتَحَدَّثٌ عنه.
وعلى
الرغم
من أنَّ النحاة يفرقون بين هذه الأبواب الثلاث، إلا أنَّ إبراهيم مصطفى يراه تفريقاً لا يخضع للمنطق اللغويِّ وطبيعة
استخدام اللغة، وإنَّما هو تفريق أملته الصناعة النحويَّة، إذ إنَّ النحاة لا
يفرقون في الأحكام بين الفاعل ونائب الفاعل ففي هذين المثالين: كُسِرَ الإناءُ،
وانْكَسَرَ الإناءُ .لا يوجد أي فرق في الاستخدام اللغويِّ بينهما، بل يتفقان في
أنَّ (الإناء) في كلٍّ منهما مسند إليه.
أمَّا الفاعل والمبتدأ فالنحاة يفرقون
بينهما بفروق قد لا تصمد أمام التمحيص والتدقيق فيها، فهم يفرقون بينهما بأنَّ
الفاعل واجب التأخير عن الفعل، بينما المبتدأ واجب التقديم في الأصل وإنْ جاز فيه
التأخير. وهذا الفرق يُعْتَبَرُ عند إبراهيم مصطفى فرقاً صناعيَّاً استحدثه النحاة
مراعاة لأصول الصناعة عندهم، حيث لا يوجد فرق في المعنى بين جملتي: ظهرَ الحقُّ.
والحقُّ ظهرَ. حتى يعتبر النحاة (الحق) في الجملة الأولى فاعلاً، ويعتبروه مبتدأ
في الجملة الثانية، و المشترك بين الجملتين أنَّ (الحقّ) فيهما مستندا إليه،
والمسند إليه يجوز تقديمه وتأخيره حسب ما يقتضيه السياق. وكذلك من طرق التفريق
بينهما عند النحاة أنهم يجيزون حذف المبتدأ ولا يجيزون حذف الفاعل، ومثال ذلك:
الإجابة عن سؤال: كيف زيد؟ فإنْ قيل: دَنِفٌ ، فالمبتدأ محذوف. وإنْ قيل: دَنِفَ،
فالفاعل ضمير مستتر. وكل ذلك عنده صناعة نحويَّة لا غير. ومن الفروق أيضاً
اشتراطهم المطابقة في العدد بين المبتدأ والخبر، ويظلُّ الفعل موحداً حتى ولو كان
الفاعل جمعا أو مثنىً. حيث يقال: فازَ الشهيدُ.
وفازَ الشهداءُ. بينما يقال في المبتدأ والخبر: الشهيدُ فائزٌ. والشهداءُ
فائزون. حيث تُلاحَظُ المطابقة في العدد بين المبتدأ والخبر، وتنعدم بين الفعل
والفاعل. وهذا الفرق صناعيٌّ متكلف أيضاً في رأي إبراهيم مصطفى، لأنَّ المطابقة في
الجملتين تأتي تبعاً لتقدُّم المسند إليه أو تأخُّره،(22) فإذا تقدَّم المسند إليه
وجب أنْ يحمل المسند إشارة إليه تطابقه في العدد، وإذا تأخَّر كان المسند مفرداً
كما في الأمثلة الاتية:
1.الشهداءُ
فازُواْ. 2. فَازَ الشهداءُ.
3.
الشهداءُ فائزون. 4. فائزٌ
الشهداءُ. (*)
وكذلك
يفرقون بينهما على أساس المطابقة في النوع من حيث التذكير والتأنيث، حيث يعتبر
النحاة أنَّ المطابقة في النوع بين المبتدأ والخبر ألزم منها بين الفعل والفاعل،
وذلك لأنَّهم يوجبون التأخير في الفاعل والتقديم في المبتدأ، وهو يري أنَّ
المطابقة في النوع تكون فيهما معاً إذا تقدَّم المسند إليه و تأخَّر المسند.(23)
وبذلك يوحِّد إبراهيم مصطفى هذه الأبواب الثلاث – الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ-في
باب واحد يطلق عليه اسم المسند إليه وحكمه الرفع وله علامة واحدة هي الضمَّة.
المضاف إليه (المجرور):
كل مجرور عند إبراهيم مصطفى هو مضاف إليه،
سواء أكانت هذه الإضافة بأداة نحو: خصبٌ في الأرضِ، أم بغير أداة نحو: خصبُ
الأرضِ، وهو لا يخالف النحاة في ذلك ، ويلاحظ أنَّ الإضافة هي أكثر أبواب النحو
دوراناً في الكلام، فالعرب قد تضيف لبيان الفاعل نحو (خلقُ اللهِ)، أو لبيان
المفعول نحو (خلقُ السماوات) أو لبيان المكان نحو (ظباءُ وَجْرَةٍ)،(**) أو لبيان
الزمان نحو (برد الشتاء)، أو لبيان
الموصوف نحو (حسنُ الوجه)، أو لبيان الصفة نحو ( كلمةُ الحقِّ)، وقد يستخدمونها
للتفضيل نحو (أعْلَمُ القومِ)، وقد تكون الإضافة أسلوبا للبيان نحو (بناتُ الدهر)،
و(أخو الصدقِ) . وقد يضيفون إلى الكلمتين نحو (غلامُ عبدِاللهِ)، وقد يضيفون
الكلمتين نحو (كعبدِ شمسِكُمْ). وكذلك حروف الجر (الإضافة) كثيرة في العربية
ومتعددة ، وتوسَّع العرب في استعمالها
وإنابتها بعضها عن بعض.(24) وخلاصة القول في هذا الشأن أنَّه يتَّفق مع النحاة في
هذا الباب.
التوابع عند إبراهيم مصطفى:
تُعْتبَرُ ظاهرة المماثلة بين الكلمات
والمشاكلة بينها من الظواهر الشائعة في العربيَّة، وما السجع في النثر والقافية في
الشعر والفاصلة في الآية إلَّا شواهد على ذلك. ومن المماثلة بين الكلمات أيضاً
المماثلة في العلامة الإعرابية والتي يسميها النحاة اتباعاً فسمُّوا الكلمة الأولى
متبوعاً والأخرى تابعاً قد قام إبراهيم مصطفى بدراسة هذه التوابع ليبيَّن إلى إيِّ
مدىً تتفق مع الأصول التي قرَّرها في نظريَّته. وقد قسَّم التوابع إلى قسمين هما:
القسم الأول - العطف: ومنه عطف النسق،
وذلك نحو قولك: جاءَ زيدٌ وعمرو. ويرى إبراهيم مصطفى في ذلك أنَّ كلّاً من الاسمين
مُتَحَدَثٌ عنه، إذ يمكن تأخير الحديث أو المسند إليه نحو: زيدٌ وعمرو جاءا، لذلك
يستحقُّ كلٌّ من الاسمين الرفع أصالة، اذ ليس الأوَّل فيهما بأولى بالإتباع من
الآخر، ولا الآخر محمولاً على الأوَّل، فكلاهما له إعراب المُسْنَد إليه وهو
الرفع. وكذلك الأمر بالنسبة إليهما في حال الإضافة نحو: مالُ زيدٍ وعمرٍ، فكلاهما
يستحقُّ الكسر بالإضافة أصالة، وليس في العطف أتباع وإنَّما هو أشراك وبذلك لا
يُعْتبَرُ العطف باباً خاصاً ولا يعدُّ من التوابع، وليس من حقِّه أنْ يُفْرَد
بالدراسة.(25)
القسم الثاني- بقيَّة التوابع: ويقصد بذلك
البدل وعطف البيان والتوكيد فمنها ما تكون فيه الكلمة الثانية بمنزلة المكمِّلة أو
المتمِّمة للمعنى بالنسبة للكلمة الأولى، بحيث لا يُفْهَمُ المعنى المراد إلَّا
بهما معاً وذلك كما في قولك: استشرْ عاقلاً نصيحاً. فالمراد بالاستشارة هنا ليس
العاقل وحده ولا النصيح وإنَّما من يجمع الصفتين معاً، وهذا النوع من التوابع حكمه
أن يكون للثاني ما للأول منهما من إعراب وتعريف وتأنيث وتذكير، وذلك لاتصال المعنى
فيهما.(26) ومن التوابع ما لا تكون فيه
الكلمة الثانية بمنزلة المكمِّلة أو المتمِّمة للأولى من حيث المعنى، بحيث يكون
لكلٍّ منهما معنىً مستقل بالفهم، إلا أنَّ اقترانهما يزيد الثانيةَ بالأولى وضوحاً
أو تأكيداً ما كان ليتمُّ لو لم يقترنا معاً. وذلك كما في قولك: زارني محمدٌ
أبوعبدُاللهِ. وقولك: لقيتُ القومَ أكثرَهُمْ أو كلَّهُمْ . ولك أن تقف على الكلمة
الأولى مثل: زارني محمدٌ، فيُفْهَمُ المعنى، أو تقول: زارني أبو عبدُاللهِ
فيُفْهَمُ نفس المعنى، وبجمعهما معاً: زارني محمدٌ أبو عبدُاللهِ، يزداد المعنى
بياناً وتأكيداً. وهذا النوع من التوابع الحكم فيه أنْ يكون لهما الرفع للإسناد،
والجرُّ للإضافة، وبذلك يخلص إبراهيم مصطفى إلى أنَّ هذه التوابع تختلف من حيث المعنى إلا أنَّها تستحق حكماً
إعرابياً مما ذكر أصالة لا تبعيَّة. أمَّا النعت السببيُّ فهو يأخذ حكمه الإعرابيَّ
على المجاورة لا على أنَّه نعت سببيٌّ، وذلك نحو قولك: رأيت فتىً باكيةً عليه
أمُّه. فـ(باكيةً) ليس نعتاً لـ(فتىً)،
لذلك يكون حكمه الإعرابي مُسْتَمَدٌّ عن طريق المجاورة لا التبعيَّة.(27)
تابع جديد (الخبر):
يجعل إبراهيم مصطفى الخبر تابعاً من
التوابع، بمعنى أنَّه يأخذ حكم الرفع بالاتباع وليس بالأصالة كما هو عند النحاة،
وهو بذلك يخالفهم في حكم الخبر وإنْ كان يستدلُّ على مخالفتهم ببعض كلامهم، فمن
ذلك استشهاده بقول سيبويه:((إنَّ الخبر إنَّما رفع من حيث كان من المبتدأ هو
هو)).(28) وقد استشهد إبراهيم مصطفى بهذا النصِّ على أنَّ الخبر يأخذ حكم الرفع
لأنَّه بمنزلة الشيء الواحد من المبتدأ، أيْ هو بمنزلة المُكَمِّل له في المعنى
كما في التوابع، وهذا مخالف لرأي النحاة إذ لا يعاملون الخبر معاملة التوابع ويري
إبراهيم مصطفى سبب استبعاد النحاة للخبر من التوابع - أنَّهم لاحظوا أنَّ الخبر
يأتي منصوباَ أحياناً والمبتدأ مرفوع كما في باب (كان)،(29) وكذلك قد يأتي الخبر
مرفوعاً والمبتدأ منصوب كما في باب(إنَّ)، ويردُّ إبراهيم مصطفى على هذا الاستشكال
بأنَّهم قد أخطأوا في هذين البابين، ففي باب (كان) المُتَحَدَّثُ عنه أو
المُسْنَدُ إليه هو الذي سموه اسم (كان)، وليس الخبر ما جعلوه هم خبراً في جملة: كانَ زيدٌ قائماً. فليس الخبر في هذه الجملة (قائماً) وإنَّما
الخبر هو جملة (كانَ قائماً)، وبذلك لا
يكون الخبر (قائماً)، فلا يلزمه أن يتبع المبتدأ في الإعراب. أمَّا بالنسبة لنصب
اسم (إنَّ) فسبق لإبراهيم مصطفى أنْ بيَّن أنَّ حكمه الرفع في الأصل ولكنه نصب
لأسباب ذكرها فيما قبل.(30) وبذلك يرى
إبراهيم مصطفى أنَّه قد أزال هذا الاستشكال الذي يمنع من تابعيَّة الخبر، فيصبح الخبر تابعاً من
التوابع.
إعراب اسم (لا) النافية للجنس:
يرى إبراهيم مصطفى أنَّ الاسم المنصوب بعد
(لا) غير مُسْنَد إليه وليس بمضاف، وبذلك يستحقُّ الفتحة باعتبارها أخفَّ الحركات،
والتي لا تدلُّ على معنىً إعرابيٍّ. ويعتبر هذا النوع من الجملة جملة ناقصة
الإسناد، فعلى الرغم من أنَّ جُمَلاً مثل: لا ضيرَ. ولا فوتَ. ولا بأسَ تبدو صوراً
لجمل اسميَّة، إلا أنَّ المتأمل لا يجد بعدها ما يُحدَّثُ به عن تلك الأسماء
الواقعة بعد (لا).(31)
باب ( ظنَّ):
ويعتبره إبراهيم مصطفى من الأبواب ذات
الوجهين، أي: التي تحتمل أكثر من إعراب، حيث أنَّ للنحاة أحكاماً في إلغائها
وتعليقها. أما عنده فلا مجال للقول بجواز الرفع والنصب فيه، ولا مجال أيضاً لتفضيل
أحد الوجهين على الآخَر، بل يجب الاعتماد على المعنى المراد، والذي سيؤدِّي بدوره
إلى وجه إعرابيٍّ من الأوجه
المُحْتَمَلة.(32) وفقا لذلك يمكن القول: ظنتُ زيداً ذاهباً، إذا كان القصد الإخبار
بأنَّك تظنُّ أمراً. ويكون الحديث بذلك عن نفسك فيكون حكم الاسمين النصب وليس
فيهما من مُتَحَدَّثٌ عنه (مُسْنَدٌ إليه) حتى يرفع. أمَّا إذا كان همُّ القائل
الإخبار عن ذهاب زيد نحو قولهم: زيدٌ ذاهبٌ، ثم يقول: هذا ظني، أو أظنُّ، أو
ظننْتُ. فهنا يكون كلامان(جملتان)، وحكم الاسمين الرفع، وأسلوب الكلام أنْ يتأخَّر
الفعل ويتقدم الاسمان، وبذلك يكون ترتيب اللفظ في النطق مطابقاً لترتيب المعنى في
نفس المتكلِّم، وهو أمر يمكن أنْ يُفْهَمَ أيضاً من قولهم: زيدٌ أظنُّ ذاهبٌ.
أمَّا الأدوات التي يعدُّها النحاة معلِّقة للفعل، فيعتبرها إبراهيم مصطفى دلائل
على أنَّ الكلام كلامَيْنِ، وأنَّ الثاني منهما مُسْتَقِلٌّ مَقْصُودٌ بالإخبار
عنه، ويذكر معه ما يدلُّ على ابتداء الكلام واستئنافه، وبذلك لم يأتي في منزلة
اللاحق، وإنْ كان في اللفظ متأخر.(33)
باب الاشتغال:
وفيه يجيز النحاة النصب والرفع في بعض
المواضع، ويختارون النصب أو الرفع في
مواضع أخرى، أمَّا إبراهيم مصطفى فيري أنَّه ليس هنالك جواز في الرفع والنصب أو
الترجيح بينهما، بل قوام كل ذلك المعنى، فإذا كان المراد التحدُّث بالفعل والإخبار
بـه عن فاعله فالحكم عنده النصب، أمَّا إذا كان التحدُّث عن الاسم فالحكم عنده
الرفع.(34)
كان ذلك بعض ملامح نظريَّة إبراهيم مصطفى،
والتي اعتبرها بديلاً مناسباً من فكرة العامل النحويِّ، وتوقعَّ لها أنْ تسهِّل
الدرس النحويَّ وتقرِّبه إلى أفهام الدارسين. وقد ذكر أنَّه اقتصر في هذه
النظريَّة على دراسة إعراب الاسم، وتركَ إعراب الفعل لوقت آخر، حتى يستفيد مما
سيوجه لهذه النظرية من نقد.(35)
النقد الذي وُجِّهَ للنظريَّة:
كتب طه حسين تقديم كتاب (إحياء النحو)،
وتنبأ له بأنَّه سيثير كثيراً من الدهشة والضيق، ضيقاً قد يصل إلى حد الخصومة
والإنكار حيث يقول:((وما أحسبني أخطئ إن قدرت أنهم سيدهشون له، وأن كثيرا منهم
سيضيقون به، وقد يتجاوزون الضيق إلى الخصومة العنيفة والإنكار الشديد.))(36) وقد
كان طه حسين على حق فيما ذهب إليه بخصوص هذا الكتاب، إذ أثار حفيظة علماء الأزهر،
فتصدى له بالنقد أحد أبناء الأزهر ألا وهو محمد عرفه، وذلك في كتابه (النحو
والنحاة بين الأزهر والجامعة) واعتبره بعضهم صراعا بين الأزهر والجامعة وكان من
واجب ((الأزهر أن يبيِّن للناس رأيه في هذا الحدث، فإن كان حقاً حمد للجامعة حقها،
وإن كان باطلاً أبان عن بطلانه وحمد لها سعيها.)).(37) وقد تمثَّل نقد عرفه وغيره للنظريَّة فيما يلي:
أولاً-
القول بمعاني حركات الإعراب أمر سُبِق إليه ولم يكن أوَّل من قال به.(38)
ثانيا-
قيام النظريَّة على قرينة الحركة الإعرابية يُعدُّ فهماً قاصراً لتحليل الجملة
وهنالك قرائن أخرى لا
تقلُّ
أهميَّة عنها.(39)
ثالثاً-
اعتبار الفتحة مثل سكون العامَّة مقارنة قاصرة، فالفتحة حركة لا يمكن أنْ تُقارن
بانعدام الحركة (السكون).(40)
رابعاً-
اعتماد النظريَّة على ادعاءات لا تستند على دليل في محاولتها إثبات أنَّ اسم
(إنَّ) حقَّه لرفع. وعلى افتراضات مماثلة في تفسير إعراب المنادى العلم والنكرة
المقصودة.(41)
تقويم نظريَّة إبراهيم مصطفى:
يتَّفق الباحث مع ما ذكره الدارسون من قصور في
النظريَّة إلَّا أنَّه يرى أنَّ معظم النقد الذي وُجِّهَ لهذه النظريَّة قد تركَّز
على جوانب جزئيَّة منها، فباستثناء صاحب كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة)
كان الدارسون يكتفون بتسجيل اعتراضهم على بعض الجوانب النظريَّة منها دون سبر
أغوارها لبيان إلى أيِّ مدىً نجح إبراهيم مصطفي في تحقيق أهدافه من وضعه لهذه
النظريَّة، وإلى أيِّ مدىً كان موفَّقاً في وضع أصول جديدة تتوافق مع الجوانب
التطبيقيَّة لها. وعليه يمكن تقويم هذه النظريَّة وفقا لمدى قدرتها على تحقيق أهدافها
التالية:
الهدف الأول- البحث عن معاني علامات الأعراب: وقد ذكر إبراهيم
مصطفى أنَّه قد توصَّل إلى اكتشاف هذه المعاني مما استنبطه من كلام النحاة،
فالضمَّة عنده علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة، أمَّا الفتحة فليست علامة إعراب
إنَّما هي حركة خفيفة مستحبّة عند العرب ، يستخدمونها في شكل آخر الكلمة عندما لا
تكون في أيٍّ من وضعي الإسناد والإضافة.(42) وقد رُدَّ على هذا الزعم بأنَّه
مُسْتنَبَط من كلام النحاة فيما عدا قوله الفتحة ليست علامة إعراب، وقد فهم عنه
القول الاخير – بخصوص الفتحة – خطأً، حيث زعم بعض الباحثين عدم صحَّة هذا الرأي.(43)
ولكن مع ذلك يظلُّ رأياً يحمل جانباً من
الصواب، حيث أنَّ كل المنصوبات لا يجمع بينهما معنىً تركيبيٌّ في الكلام، فإذا
كانت الضمَّة تدلُّ على معنى الإسناد في التركيب، والكسرة تدلُّ على معنى الإضافة،
فإنَّ المنصوبات لا تشترك في معنىً تركيبيٍّ ، فمنها ما يدلُّ على ما وقع عليه
الفعل، أو كيفيَّة حدوثه، أو رفع الإبهام عنه، أو عدد مراته، وغير ذلك من المعاني
التي تُفْهَمُ من المنصوبات في التركيب.(44) وبذلك يُسَجَّلُ لإبراهيم مصطفى رأيه
بخصوص الفتحة، وأنَّها ليست علامة إعراب اذا كان هذا هو المقصود من كلامه.
ثانيا- هدم نظريَّة العامل: والتي اعتبرها
سبباً في تعقيد النحو العربيِّ وصعوبته على الدراسين، وقد اعتبر هدمها هدفاً
مشروعاً ، يمكن أن يسهم في تيسير نحو العربيَّة، لذلك قرَّر إنشاء نظريَّته الخاصة
في الإعراب، والتي ستقوم بهدم هذه النظريَّة والحلول محلها. ولم ينجح إبراهيم
مصطفى في تحقيق هذا الهدف، وذلك لجملة من الأسباب التي حالت دون تحقيقه لهذا
الهدف، والأسباب هي:
1. النقصان: ذلك لأنَّ النظريَّة لم نتعرَّض
لتحليل الفعل على الرغم من أنَّه جزء رئيس في بعض الجمل، فضلاً عن أنَّ أحد اقسامه
يعتريه التغيير(الفعل المضارع)، إذ يأتي مرفوعاً مرة، ومنصوباً أخرى، ومجزوماً
ثالثة، وهذا التغيير يحتاج إلى تفسير، وقد فسَّرته نظريَّة العامل بدخول عوامل
عليه، وقد ترك إبراهيم مصطفى أمر الفعل حيث قال: ((رأيت أن استأخر بإعراب الفعل
زمناً، واتقدم إلى الناس في هذا البحث بإعراب الاسم وحده.)).(45) ويبدو أنَّه لم
يجد متسعاً من الوقت لدراسة الفعل وفقا لهذه النظرية، إلَّا أنَّه تعجل بالتصريح
بهدم نظريَّة العامل، والتبشير بنظريَّته هذه على الرغم من أنَّها يعتريها نقص
جوهري يقلِّل من الانتفاع بها في دراسة النحو.
2.القصور في الجوانب النظريَّة: بنى إبراهيم
مصطفى نظريَّته على الأصول التي سبق ذكرها، وقد وجد بعض أجزاء الكلام يخرج عن تلك
الاصول، فحاول أنْ يجد مخرجاً لذلك، حيث عمد إلى حجج استدلَّ بها على أنَّ تلك
الأجزاء الخارجة عن أصوله كانت في السابق تسير وفقاً لهذه الأصول التي قام بذكرها،
فمن ذلك ما استدل به من حجج على أنَّ اسم (إنَّ) كان من حقه الرفع وإنَّما نُصِبَ
على التوهم.(46) فإذا تمَّ التسليم بصحَّة ما توصل إليه فإنَّه يكون قد بنى رأيه
ذلك على القليل الشاذ وترك الكثير المطرد في تقرير القاعدة، وهو أمر يخالف الطريقة
العلميَّة الصحيحة.(47) ومن القصور في هذا
الجانب أيضاً عدم التطرُّق إلى خروج بعض الظواهر اللغويَّة عن إطار الأصول التي
وضعها، فمن ذلك مجي المُسْنَد إليه مجروراً ، وذلك كما في قولهم: ما في يدي حيلةٌ،
وما في يدي مِنْ حيلةٍ. وكلمة (حيلة) في الجملتين مُسْنَد إليه ومع ذلك جاءت
مجرورة في الجملة الثانية.(48) ويتضح من ذلك أن الأصول الثلاثة لنظريَّة إبراهيم
مصطفى غير مطردة وقد حاول أن يفسِّر خروج بعض الظواهر عنها ويجد حججاً لها، كما
ترك ظواهر أخرى خرجت عنها دون ذكر تفسير لها، ودون الإقرار بوجودها من الأصل.
3.القصور في الجوانب التطبيقيَّة: سبق أن ذكر
إبراهيم مصطفى أنَّ الضمَّة علم الإسناد، وبما أنَّ كل إسناد يتكون من طرفين:
مُسْنَد إليه و مُسْنَد، إلَّا أنَّه عاد وقال بوجود جمل ناقصة الإسناد مثل: لا
بأسَ، ولا ضيرَ،(49)وذلك من أجل تبرير الفتحة في كلٍّ من (بأس) و(ضير) فجعلهما غير
مُتَحَدَّث عنه، والجملة ناقصة الإسناد، وهو بذلك يخالف أمراً عقليا كون كل جملة
تتكون من مُسْنَد و مُسْنَد إليه، وإلَّا لَمْ تعد تركيباً.(50) ومن القصور في
الجانب التطبيقيِّ في النظريَّة أنَّه جعل الخبر تابعاً من التوابع على الرغم من
أنَّ بعض التوابع يشترط فيه المطابقة في التعريف والتنكير كالنعت مثلاً، ومنها ما
لا يُشْتَرطُ فيه ذلك، ولم يبيِّن إبراهيم مصطفى من أيِّ النوعين هو الخبر.(51)
فضلاً عن أنَّ اعتبار الخبر تابعاً من التوابع يتناقض مع الأصول التي وضعها
لنظريَّته اذ يجعل الضمَّة علم الإسناد، وبما أنَّ المبتدأ كلمة مرفوعة وهو
مُسْنَد إليه، فاين المسند في الجملة إذا كان الخبر تابعاً ؟ وليس هذا فحسب بل
يعود لينقض هذا المبدأ الذي قرَّره– جعل الخبر تابعاً – حيث يقول في موضع آخر من
كتابه يتحدث فيه عن كان واسها وخبرها في جملة: كانَ زيدٌ قائماً، يقول عن ذلك)):
الخبر هو (كان قائماً) فليس (قائم) بخبر ليزم أن يتبع المبتدأ في إعرابه.)).(52)
ويفهم من هذا الكلام أنَّه يجعل من كان زيد) خبراً لاسم كان(زيد)، وبذلك يجعل
الدارس للنحو العربيِّ– وفقا لهذه النظرية – على حيرة من أمره فأحيانا سيجد الخبر
تابعاً من التوابع، وأخرى يكون الخبر خبراً وفقاً لما قرره النحاة.
ثالثاً- تغيير وجهة البحث النحويِّ: اتهم إبراهيم
مصطفى النحاة بتضييق حدود البحث النحويِّ وقصره على العامل النحويِّ، فدعا إلى
دراسة قوانين الكلام وطريقة تأليفه وعلاقة كلِّ كلمة بالأخرى في التركيب.(53) وهو
أمر وجده صداه عند الباحثين من بعده فمن ذلك قيام تمَّام حسَّان بدراسة النظام
النحويِّ للعربيَّة وفقاً لقرائن التعليق والتي تُسْتَقَى من المقام وما يدلُّ
عليه.(54) كما دعا إبراهيم مصطفى إلى جمع أساليب العربيَّة ممَّا فرَّقه النحاة
على الأبواب النحويَّة المختلفة انسياقاً خلف فلسفة العامل، وذلك مثل أسلوب النفي،
وأسلوب التوكيد، وغيرهما من الأساليب.(55) وهذه الدعوة وجدت صداها عند بعض
الباحثين ومنهم مهديٌّ المخزوميُّ، والذي قام بجمع الأساليب في أبواب معيَّنة
كأسلوب النفي، وأسلوب التوكيد، وأسلوب الاستفهام ، مفصِّلاً في ذلك عن خصائص كل
أسلوب وأدواته وصيغه.(56)
الخلاصة:
يتضح مما سبق ذكره أنَّ نظريَّة إبراهيم
مصطفى لمْ تنجح في تقديم بديل مناسب من فكرة العامل النحويِّ لما فيها من نقصٍ
جوهريٍّ في طريقة تحليل الجملة، بالإضافة إلى قصورها في الجوانب النظريَّة
والتطبيقيَّة، وتناقض معطياتها في بعضٍ من أجزائها. ومع ذلك قد نجحت في تحديث
البحث النحويِّ، وتوجيهه نحو وجهة جديدة، فضلاً عن أنَّ أفكارها الناقدة للنحو
العربيِّ دعت الباحثين إلى مقاربة التراث النحويِّ والكشف عن جوانب كانت خفيَّة
منه.
___________________________________
(1)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 13.
(2)
المصدر السابق ، ص: 15.
(3)
المصدر نفسه ، ص: ( 32 – 33).
(4)
نفسه، ص: 114.
(5)
نفسه ، ص: (18-20).
(6)
نفسه ، ص: 42.
(7)
نفسه ، ص: ( 43– 48).
(8)
نفسه، ص: 49.
(9)
سورة طه: الآية: 63.
(10)
ابن أبي طالب القيسيّ، مكِّيّ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تــ:
محي الدين رمضان، مجمع اللغة العربية، دمشق، (ط. د)، 1974م، جــ: 2، ص: 99. وقد
قرأ حفص وابن كثير بتخفيف (إنْ) وقرأ الباقون بتشديدها. وقرأ أبو عمرو
بالياء(هذين) وقرأ الباقون بالألف (هذان).
(11)
سورة المائدة: الآية: 69.
(12)
البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب اللباس، باب عذاب المصوِّرين يوم القيامة، حديث
رقم: 5950، ص: 1495. وهو برواية: ((إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً عندَ الله يومَ
القيامةِ المصوِّرون.)). ولا وجه للاستشهاد بهذه الرواية على رفع اسم إنَّ.
(13)
ابن أبي خازم، بشر، ديوانه، تـــ: مجيد طرَاد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:1،
1994م، ص:116. وفيه برواية (ماحَيِينَا) بدلاً من (ما بقينا).
(14)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 51.
(15)
سيبويه، عمرو بن عثمان، تـ: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: 3،
1988م، جـ: 1، ص: 419.
(16)
المبرِّد، محمد بن يزيد، المُقْتضَب، تـــ: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء
التراث، القاهرة،(ط. د)، 1994م، جـ:4، ص: 136.
(17)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 54 .
(18)
المصدر السابق ، ص: (55-60).
(19)
المصدر نفسه ، ص: 60 .
(20)
نفسه، ص: (71-72).
(21)
نفسه ، ص: ( 72-73).
(22)
نفسه ، ص: ( 44 – 45).
(*)
يُشترَطُ أنْ يُسْبَقُ هذا الوصف بنفيٍ أو استفهام عند البصريين، ولا يشترط
الكوفيون والأخفش ذلك، وتابعهم ابن مالك في ذلك.
(23)
مصطفى، إحياء النحو، ص: (46-47).
(**)
اسم موضع بين مكَّة والبصرة، اشتهر بكثرة وحوشه. انظر: ابن منظور، لسان العرب، جـ:
5، مادة(وجر)
(24)
مصطفى، إحياء النحو، ص: (52-54).
(25)
المصدر السابق، ص: (75-76).
(26)
المصدر نفسه، ص: 77.
(27)
نفسه ، ص: (75-80).
(28)
سيبويه، الكتاب، جـ:
(29)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 81.
(30)
المصدر السابق ، ص: ( 80- 81)
(31)
المصدر نفسه، ص: 88.
(32)
نفسه، ص: (90-91).
(33)
نفسه ، ص: 92.
(34)
نفسه، ص: 95.
(35)
نفسه، ص: 114.
(36)
نفسه، ص: 7.
(37)
عرفة، محمد أحمد، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، مطبعة السعادة، القاهرة ، (
ط . د)، ( ت . د)، ص: 3.
(38)
المصدر السابق، ص: (116-117).
(39)
حسَّان، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، ص: (185-186).
(40)
أبو المكارم، على، الحذف والتقدير في النحو العربيِّ، دار غريب للطباعة والنشر،
القاهرة، ( ط . د) ، 2008م، ص: 177.
(41)
الياسري، علي مزهر، الفكر النحويُّ عند العرب، الدار العربيَّة للموسوعات، بيروت،
ط: 1، 2003م، ص: (407- 409).
(42)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 42 .
(43)
الياسري، الفكر النحويُّ عند العرب، ص: 405.
(44)
أبو جناح، صاحب، دراسات في النحو العربيِّ وتطبيقاتها، دار الفكر، عمَّان، م: 1،
1998م، ص: (24-25).
(45)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 114.
(46)
المصدر السابق، ص: 52.
(47)
الياسري، الفكر النحويُّ عند العرب، ص: 409 .
(48)
الحلوانيّ، محمد خير، أصول النحو العربيِّ، الناشر الأطلسيُّ، ( م. د )، ط: 2،
19983م، ص: (140-141).
(49)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 89.
(50)
عرفه، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، ص: 130.
(51)
المصدر السابق، ص: 197.
(52)
مصطفى، إحياء النحو، ص: 81
(53)
المصدر السابق ، ص : 17.
(54)
حسَّان، تمَّام، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، (ط.
د)، 1994م ، ص: ( 191 – 240).
(55)
مصطفى، إحياء النحو، ص: ( 18 – 19).
(56)
المخزوميُّ، مهدي، في النحو العربيِّ نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت،
ط:2،1986م ، ص: (234 – 311).

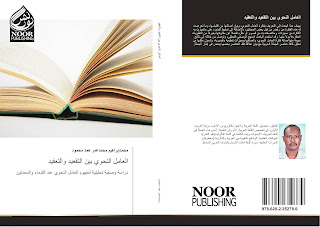



تعليقات
إرسال تعليق